هل إنقلاب 30 يونيو هو الأخير ؟ الإنقلابات العسكرية: الأسباب والمحفزات والمعالجات
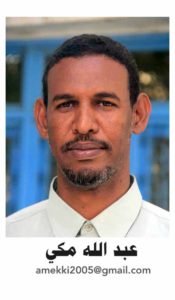
بقلم : عبد الله مكي
amekki2005@gmail.com
يُصادف تاريخ 30\6\2020م الذكرى واحد وثلاثين لإنقلاب الإنقاذ في الثلاثين من يونيو 1989م، وتمر الذكرى وحكومة البشير خارج السلطة، وهنا يتبادر لأذهان الكثيرين سؤال مهم، هل سيكون هذا هو الإنقلاب الأخير ؟ ونهاية الدورة الخبيثة (ديمقراطية – انقلاب – ثورة شعبية – فترة انتقالية – ديمقراطية – انقلاب) الخ. أم السودانيون موعودون بسلسلة إنقلابات أخرى؟ ولو بطريقة مختلفة؟
لقد شكّلت حرب الجنوب رأس الرمح في الطريقة التي تُدار بها الدولة السودانية، وأثّرت في أنظمة الحكم العسكري والمدني معاً، ومهّدت لتقوية دور الجيش في السياسة، وتكاثرت بسببها الإضطرابات السياسية والخلافات الأيدولوجية.فسنوات استقلال السودان الـ(64)كان نصيب الأسد فيها للحكومات العسكرية، حيث حكمت حوالي (54عاماً) أمّا الحكومات الديمقراطية المنتخبة فكان نصيبها من الحكم (10 سنوات فقط)، فهل فعلاً أنَ حل مشاكل السودان بيد العسكريين؟ وهل توق بعض السودانيين (لعسكري نضيف) – كما يُرددون في بعض نجواهم – هو قناعة بالانقلابات العسكرية؟ أم نتيجة للإحباطات المتراكمة؟ ولماذا يتدخل العسكريون في السياسة؟ وما جدوى تلك الانقلابات؟ وما هو دور القوى السياسية في هذه الانقلابات؟ وكيف يُمكن تلافيها مستقبلاً؟ وهل سيكون انقلاب الإنقاذ فعلاً هو الإنقلاب الأخير في البلاد؟
المؤسسة العسكرية
تُعتبر المؤسسة العسكرية من أهم المؤسسات التى خلفتها الدولة الإستعمارية، وهي العمود الفقري للدولة المركزية وتُمثّل أهم العناصر التي تناولتها دراسات ما بعد الإستعمار.
في كتابه (الجيش والمجتمع والسياسة في البلدان النامية)يقسم غيورغي ميرسكي جيوش بلدان آسيا وأفريقيا من حيث طابع الظهور إلى أربعة أنواع:
أولاً: جيوش الإستعمار الجديد: وهي جيوش البلدان التي كانت ذات سيادة في السابق وكانت لديها قوات مسلحة قبل الفترة التي ظهر فيها تأثير الإستعمار بهذا الشكل أو ذاك ومنها جيوش تركيا وإيران وأثيوبيا وأفغانستان وتايلاند واليمن.
ثانياً: الجيوش الإستعمارية سابقا: أي التي أسسها المستعمرون (وأُورثتها) السلطة الوطنية كما في الهند وباكستان والعراق وسوريا ومصر وزائير وبلدان أخرى.
ثالثاً: الجيوش التي ظهرت في سياق حروب التحرر الوطني(بورما – أندونيسيا – الجزائر).
رابعاً: الجيوش التي شُكلت بعد تأسيس الدولة الوطنية(أغلبية جيوش الدول الأفريقية).
هل الجيش مهم وضروري؟
يدور النقاش دائماً عن أهمية وضرورة وجود قوات مسلحة، فبين آراء متطرفة بعدم جدواها، إلى تشبُّه بالتجربة السويسرية، مرورا بفكرة(تجييش الشعب). فالذين يُنادون بضرورة وجود قوات مسلحة – رغم العبء الهائل الذى تلقيه على الميزانية – يعزون مناداتهم هذه إلى حجج واقعية مثل: خطر التدخل الخارجي، النزاعات الإقليمية، والحركات الانفصالية والتي قد تُؤدي لزعزعة أمن واستقرار البلاد. ومهنة العسكري في أغلب بلدان العالم مهنة محترمة تقليدياً، كما شاع عند أهل بعض المناطق في السودان قديماً: (ولدنا كان نجح للعسكورية، وكان سقط (أي فشل في الدراسة) فهو للطورية (أي الزراعة)، فيما عدا بعض المناطق والأقاليم الصينية والتي شاع فيها القول المأثور: (لا تصنع المسامير من الحديد الجيد ولا يتحول الإنسان الطيب إلى جندي).
المؤسسة العسكرية والسياسة
إنّ تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية أصبح سمة مائزة للدول النامية وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين وإلى نهايته. فبين عامي( 1970 – 1975م فقط حدث حوالي 40 إنقلاباً عسكرياً في 30 بلداً في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ويقول غيورغي ميرسكي:(ولم يعد نادراً في العديد من دول القارات الثلاث إنتقال السلطة إلى العسكريين مع إبتعادهم عنها فيما بعد وعودتهم من جديد في الغالب).
ولكن لماذا يتدخل العسكريون في السياسة ؟ يقول العالم النفسي الإيطالي اميليو سيرفاديو:(إنّ التعود على الحياة في الثكنات حيث الإنضباط والمراتب لا جدال فيها، وحيث الأوامر لا تُناقش مطلقا، ولا موجب للتفكير الإنتقادي، كل ذلك يُؤدي إلى الإستبداد، ويسفر الطموح إلى الإستبداد عن رغبة حتمية في جعل مثل هذا النظام المطلق يشمل الحياة الإجتماعية أيضا).
الباحث الأمريكي جورج لودج يشرح وظيفة ومهام القوات المسلحة فيقول:(إنّ الدفاع دون العدو الخارجي وظيفة مهنية للقوات المسلحة، أمّا وظيفتها الرئيسية فهي إخماد القلاقل المدنية، ومكافحة الأعمال الهدامة الداخلية، والإبقاء على إستخدام التهديد بالقوة في العملية السياسية).
كثيرون يرون أنّ القوات المسلحة لا تتدخل في الشئون السياسية إلا إذا إشتدت حدة التوترات السياسية والصراعات الحزبية وصاحبها إنفلات أمني، فيرى العسكريون أنّ واجبهم الوطني يُحتّم عليهم التدخل المباشر لإيقاف التدهور أو النزيف أو لمساندة ثورة شعبية كما في الحالة السودانية.
كتب العالم الأمريكى ث. ويكوف:(إنّ العسكريين يلتزمون بنهج للأعمال يستجيب للظروف السياسية في البلد المعني، وهم لا يمكن أن يُعتبروا مسؤولين عن وجود أو إنعدام الديمقراطية، إنّ الدور السياسي للعسكريين ليس مرضاً سياسياً إنه على الأكثر من أعراض عدم النضج السياسي). ففي السودان ما من إنقلاب إلا وكان بدعوة من جهة سياسية بعينها، أو بتخطيط كامل ومشاركة منها.
فاعلية الجيش في السياسة
طبيعة تكوين الجيوش وهيكليتها مقارنة بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العالم الثالث تجعلها أكثر فاعلية في الأداء السياسي، يقول غيوركي ميرسكي: (إنّ مركزية الإدارة والتسلسل الهرمي الصارم والإنضباط وسهولة الإرتباطات الداخلية، كل ذلك يُشكّل جانب قوة للقوات المسلحة، بالمقارنة مع المنظمات المدنية، ويساعد على زيادة فاعلية أعمال العسكريين عندما يشرعون بأداء المهمات السياسية). وهذه الفاعلية في السودان تجعل القوى السياسية المنظمة والأيدولوجية تستفيد من هذه الميزة، خاصة اليسار والإسلاميين.
دخول الجيش في السياسة كارثة!
ويرى آخرون أنّ من أكبر الكوارث هو تدخل الجيش في العمل السياسي، ما يحرف الجيوش عن أداء مهامها ووظيفتها في حماية البلاد والتفرغ للتطوير والتخصصية، وكذلك دخولها في حلبة الصراعات السياسية يُفقد المؤسسة العسكرية قوميتها وحيادها. يقول محمد أحمد محجوب في كتابه(الديمقراطية في الميزان):”أنْ يطلبالمرء من عسكري أنْ يكون رجل دولة هو أشبه بأنْ يُطلب من محامٍ أنْ يُجري جراحة في الدماغ أو عملية زرع قلب. فحيثما استولت القوات المسلحة على السلطة، كانت النتيجة الضياع والقلق والفقر في جميع نواحي الحياة والإكراه والقمع”.
دوافع الإنقلابات العسكرية
الباحثون في شأن الإنقلابات العسكرية يرون أنّ الدافع الأكبر للإنقلاب يعود إما إلى طبيعة السمات التنظيمية للمؤسسة العسكرية، وتشمل التسلسل الهرمي وطبيعة التدريب والإنضباط التنظيمي. أو إلى حماية مصالح الجيش المؤسسية عندما يتهددها خطر تقليص الميزانية أوالإهمال أووجود مليشيات منافسة، أوالتدخل السياسي في شئوونه المهنية.
درجة المهنية
الكاتب الأمريكي صمويل هنتنغتون المدير السابق لمركز الدراسات الإستراتيجية بجامعة هارفارد وأستاذ العلوم السياسية المتخصص في إدارة الحكومات، وصاحب الكتاب الشهير صدام الحضارات(The Clash Of Civilizations) قد أرسى نموذجاً تقوم على أساسه العلاقات العسكرية المدنية وهو ما سماه(درجة المهنية) فيقول:(كلما كانت المؤسسة العسكرية مهنية في مهمتها، ابتعدت عن التدخل المباشر في السياسة. وكلما قلت مهنيتها، ازدادت تدخلاً في السلطة) ويرى هنتنغتون أنّ مهنية القوات المسلحة تكمن في تجويد مهمتها الأساسية وهي حماية البلاد من التهديد الخارجي، وهي ليست معنية بقضايا الأمن والسياسة الداخلية.
منع الإنقلابات العسكرية
لكي نتجنب وقوع الإنقلابات العسكرية، ونُضعف فرصة حدوثها، لابد من توفر الأسباب الآتية:
أولاً: قوة المؤسسات المدنية وكذلك المجتمع المدني.
ثانياً: لابد من رسوخ حكم القانون وشرعية الحكومة.
ثالثاً: يجب أن تُبسط وتنتشر الحريات.
رابعاً: بالإضافة لمعرفة التأثيرات السالبة على البلد والمواطن من الإنقلابات السابقة.
خامساً: وأخيراً: قدرة النظام الحاكم التكتيكية على درء خطر الإنقلاب بهيمنته على القوات المسلحة.
خطر الإنقلاب
ونعني به الظروف السياسية والأبعاد الهيكلية التي تُرجَح قيام الانقلابات العسكرية، فقد قدّم العالمان والخبيران في الشؤون السياسية (بيلكن وسشاوفر) نموذجاً يُمكنه أنْ يُرجَح وقوع انقلاب وأسمياه (خطر الانقلاب). ويشير الخطر إلى الأبعاد الهيكلية طويلة المدى التي تُرجَح وقوع انقلاب وتشمل سمات حكومية، ومجتمعية، وعناصرمن الثقافة السياسية، والعلاقة التي تربط المجتمع بالحكومة. ويفرقا بين الأبعاد الهيكلية، والمحفزات التي تسبق الانقلاب.
محفزات الإنقلاب
وهناك محفزات عديدة تسبق عملية الانقلاب العسكري مثل: الأزمات الاقتصادية، وتدهور الأوضاع المعيشية، وإهمال الجوانب المهنية للعسكريين.ولكن تُعتبر الأزمات الحادة هي الحافز الرئيس في الإطاحة بالسلطة الحاكمة، وبرز دور السياسيين بحسبانه الأكبر في دفع العسكريين نحو استلام السلطة، وأدت المحفزات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية دوراً مهماً في إنجاح عملية استلام السلطة عبر الانقلاب.
الانقلابات في السودان
الأستاذ بجامعة الخرطوم د. حسن الحاج علي أجرى دراسة عن الانقلابات العسكرية في السودان أسبابها ودوافعها، قال:”إنّ تدخل العسكريين في السلطة في السودان ما هو إلا امتداد للعملية السياسية بوسائل الإكراه”. وقال: (الانقلاب العسكري في السودان هو استمرار للعملية السياسية بوسائل أخرى بسبب عوامل هيكلية. وعندما تزداد حالة الصراع والاستقطاب السياسي تتزايد فرص الانقلاب.
وإنّ قدرة النظام الحاكم التكتيكية في منع الانقلاب تجعل الاستقرار مرهوناً بتلك القدرة وليس بسبب السمات الهيكلية للدولة). وقدّم شرحاً ونقداً لمعظم النظريات التي تتحدث عن تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية وخلص للآتي :-
أولاً: الإنقلاب العسكري في السودان هو استمرار للعملية السياسية بوسائل أخرى بسبب عوامل هيكلية. وهذا يعني أنّ الدافع الرئيس للإنقلاب ليس السمات التنظيمية للقوات المسلحة أو المظالم الشخصية للضباط ، فهذه تُشكل فقط حافزاً مُهيئاً للإنقلاب.
ثانياً: توسع المهام المهنية للقوات المسلحة، وحكم العسكريين المتطاول، بجانب تجييش الشعب في فترة الإنقاذ، قلل الهوة بين المدنيين والعسكريين ،وجعل تداول المدنيين والعسكريين على السلطة يُنظر إليه بحسبانه جزءاً طبيعياً، من العملية السياسية في السودان.
ثاثاً: عندما تزداد حالة الصراع والإستقطاب السياسي تتزايد فرص الإنقلاب، كما تزداد للسبب ذاته فرص انهيار النظام العسكري عندما يكون العسكريون في السلطة. أي أنّ تزايد الإستقطاب والصراع السياسي يُسهم في انهيار الأنظمة المدنية والعسكرية في السودان.
رابعاً: إنّ قدرة النظام الحاكم التكتيكية في منع الإنقلاب تجعل الإستقرار مرهوناً بتلك القدرة وليس بسبب السمات الهيكلية للدولة.
وفي كلا النوعين من أنماط الحكم : المدني أو العسكري كانت الأزمات الحادة هي الحافز الرئيس في الإطاحة بالسلطة الحاكمة، وبرز دور السياسيين بحسبانه الأكبر في دفع العسكريين نحو استلام السلطة، وأدت المحفزات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والمهنية دورا مهما في إنجاح الإستلام. ولكن يظل الخلل الهيكلي هو السبب الرئيس وراء الإنقلاب العسكري، حيث لا يزال دور المجتمع المدني ضعيفا، ولا زالت الحكومة تهيمن – بجانب هيمنتها السياسية – على مفاصل المجتمع الإقتصادية والإعلامية والثقافية. وأصبح استلام السلطة كما يقول د. حسن الحاج علي:(مباراة صفرية)، بمعنى أنّ الطرف الخاسر يخرج صفر اليدين بخروجه من السلطة، أو فقدانه الأمل في الوصول إليها بصورة شرعية. في هذه الحالة إذا لم يسع لإستلام السلطة، في ظل ضعف المجتمع المدني، فإنّ انتظاره سيطول على هامش الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد.
هل إنقلاب الإنقاذ هو الأخير؟
يتوقف هذا الأمر على القوى السياسية التي قامت بانقلابات في السابق، وعلى رأسها اليسار والإسلاميون، وليس هناك فرصة لمقامرين، لأنَ التجربة تقول: إنَ الانقلابات في السودان دائماً خلفها القوى السياسية.
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ قرشي عوض، يقول:”ربما يكون انقلاب الإنقاذ الأخير، لأنّ المؤسسة العسكرية والأمنية لم تعد واحدة كما كانت في الماضي حيث يستطيع عدد من الضباط من خلال السيطرة على وحدات عسكرية حاسمة – مثل المدرعات – السيطرة على الوضع العسكري والسياسي، فالآن تُوجد عدد من المكونات العسكرية تكونت وفق ولاءات تختلف عن الجيش وتتحكم فيها قيم أبعد ما تكون عن قيم الربط والضبط التي تعمل وفقها الجيوش الإحترافية”. كذلك يُوضح الأستاذ قرشي “أنّ الجيش جرّب التعامل مع كل الأحزاب السياسية وهو الآن محتار ويتلفت عله يجد حزباً يمكن الركون إليه”.
وتعليقاً على وضع الجيش بعد إنقلاب 30 يونيو وارتباطه بالإسلاميين، يقول الأستاذ قرشي عوض :” بحكم تكوين الجيش الحالي وما قامت به الحركة الإسلامية من إحلال وإبدال بحيث تم استيعاب دفع كاملة تخرجت من الكلية الحربية وتدين بالولاء للتنظيم، أصبح من المستحيل الحديث عن دور للجيش بعيداً عن تنظيم الحركة الإسلامية”، لكنه يُؤكد أنّ بعض الدول المرتبطة بعلاقات بالسودان لن تقبل هذا الوضع:”وهذا وضع لن ترض عنه الرياض ولا القاهرة، وبالطبع فإنّ رضى هاتين العاصمتين ضروري لبقاء أي نظام في الخرطوم، ولا أظن المملكة ومصر يُرحبان بنظام إسلامي”.
وفي إجابة مباشرة عن سؤالنا هل إنقلاب الإنقاذ هو الأخير أم تتوقع إنقلاباً آخر، يقول الأستاذ قرشي عوض:”وفق التركيبة العسكرية للقوات الأمنية وللجيش تحديداً لا أتوقع وقوع إنقلاب عسكري مرة أخرى، ولكن السودان بلد العجائب”. أمّا الدكتور محمد أحمد فقيري القيادي بالتيار الإسلامي والكاتب المرموق، فله وجهة نظر ربما تلتقي مع الأستاذ قرشي عوض في بعض النقاط وتتقاطع مع أخرى، حيث يقول:” في ظني يصعب الحديث عن انقلابات كما عهدها السودان منذ الإستقلال، وهي ذات طبيعة نخبوية، صفوة الأفندية مع نخبة الجيش بنكهات مختلفة طائفية تارة ويسارية أخرى أو يمينية. فهناك متغير كبير أحدثه نظام الإنقاذ بيد أنه لم يستطع المضي فيه إلى النهاية وهو الحكم الفدرالي اللامركزي، والذي خلخل كثيراً من بنية الدولة القابضة التي ورثناها من المستعمر، ما جعل من الصعب علىالنخبة السياسية القديمة ومؤسسة الجيش أن تُمارس عادتها القديمة في تغييرالأنظمة بالإنقلابات المتكررة”.
وكشف دكتور فقيري عن سبب طول عمر الإنقاذ(30 عاماً) مقارنة مع نظام مايو(16عاماً) أو نظام عبود(6 أعوام) بالقول:” لعل الذي أطال أمد الإنقاذ هو تحالفها عبر النظام الفدرالي مع البنى الإجتماعية التقليدية إذ استطاعت بذلك تجاوز الإعتماد على نظام حزبي واحد وتجاوز مؤسسة الجيش عبر خلق مليشيات موازية كما هو في(الدعم السريع). وكذلك أكّد دكتور فقيري على صعوبة حدوث إنقلاب عسكري بالنمط التقليدي، وشرح ذلك قائلاً:” هذه المعادلة ستجعل من العسير العودة إلى نمط الإنقلابات القديم، ولكن يُمكن أنْ تفتح الباب إلى ممارسة على ذات نهج البشير في إقامة تحالفات على أساس قبلي وجهوي يدعم نمطاً استبدادياً إلى حين”.
وبعد هذا السرد والتحليل لأسباب قيام الإنقلابات العسكرية ومحفزاتها وكيفية منع قيامها، والإجابة على سؤال هل إنقلاب الإنقاذ هو خاتمة مطاف الإنقلابات العسكرية في السودان، ما زال السؤال قائماً في أذهان الكثير من السياسيين والعسكريين والمواطنين والقراء الكرام.
لحن الختام
تُعرّف بعض المدارس السياسية الأزمة الثورية: (بأنّها تلك الحالة التي يكون فيها النظام الحاكم غير قادر على الحكم أكثر من ذلك، وتكون الجماهير غير مستعدة للعيش في ظله ولو لحظة واحدة، وأن تكون هناك قوة سياسية متطلعة لاستلام السلطة ومستعدة لها).
